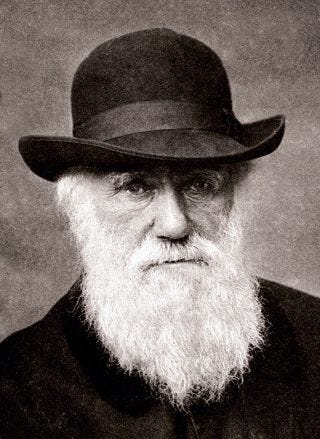لماذا يحتاج علم الوعي إلى داروين؟
الثورة التي ينشدها علم الوعي
لماذا يحتاج علم الوعي إلى داروين؟
الثورة التي ينشدها علم الوعي
ترجمة : إقبال عبيد
أهلًا بكم في «العلم والفلسفة»، حيث أكتب لجمهور غير متخصص عن أبحاثي بوصفـي فيلسوفًا ومؤلفًا وأستاذًا مساعدًا. هنا أحاول تفكيك الأسئلة الكبرى التي تحيط بالعقل، واستكشاف السبل التي تُمكّننا من فهم تنوّع أشكال الوعي لدى البشر والحيوانات، بل وحتى لدى أنظمة الذكاء الاصطناعي. هذه المقالة ليست عرضًا تقنيًا بقدر ما هي دعوة للتأمل، ويمكن الاستماع إلى نسختها الصوتية بصوتي. للاطلاع على المقالات الجديدة وحلقات البودكاست، يُرجى الاشتراك.
لماذا يوجد الوعي أصلًا؟ لا يكمن الجواب في تحليل الوعي الإنساني وحده، ولا في عزله بوصفه ظاهرة استثنائية مكتفية بذاتها، بل في العودة إلى جذوره التطورية الأولى: إلى أبسط أشكال التجربة الذاتية التي ظهرت في تاريخ الحياة. إن الوعي البشري ليس سوى حالة خاصة، متقدمة ومعقّدة، ضمن طيف واسع من العقول التي تزخر بها المملكة الحيوانية. ومن هنا تبرز الحاجة إلى منهج دارويني تصاعدي، لا يبدأ من القمم، بل من الأسس؛ منهج يعيد بناء البدايات المتواضعة للإحساس والخبرة، ثم يتتبع كيف تراكمت عليها طبقات التعقيد خطوة بعد خطوة، حتى بلغت ما نسمّيه اليوم وعيًا إنسانيًا. هذه الفكرة كانت الرسالة المركزية في كتابي «فلسفة لعلم وعي الحيوان»: أن نفهم الوعي لا بوصفه لغزًا معزولًا، بل كنتيجة لمسار تطوري طويل، لا يمكن إدراكه إلا إذا نظرنا إليه بعين داروين.
قد لا يبدو هذا الطرح، للوهلة الأولى، مثيرًا للجدل. غير أن الفلسفة، تاريخيًا، كانت شديدة التحفّظ تجاه الادعاء بأن علم الأحياء التطوري قادر على الإسهام في حلّ مشكلاتها الكبرى. لذلك كنت أتوقّع اعتراضات حادّة وردود فعل دفاعية، لكن ما حدث كان على العكس تمامًا.
في أول عشرة تعليقات نُشرت ضمن أعداد خاصة خُصّصت لمناقشة كتابي، أبدى علماء وفلاسفة على حد سواء توافقًا لافتًا مع المنهج التطوري الذي اقترحته. بل إن بعضهم مضى إلى تطبيق أطروحتي على أنواع محددة، كالفيلة والقرود، وهو ما سأتناوله بمزيد من التفصيل لاحقًا. ومع هذا الإجماع غير المتوقع، وجدت نفسي، على نحو مشوبًا بشيء من خيبة الأمل؛ إذ كنت قد أعددت نفسي ذهنيًا للدفاع عن ضرورة التطور بوصفه مفتاحًا لفهم العقل، لا للترحيب الهادئ به.
لكن هذا الهدوء لم يدم طويلًا. فقد وصلني تعليق من كريستيان دي ويرد قبيل الموعد النهائي لتقديم المساهمات. كنت قد دعوته عمدًا، نظرًا لنقاش سابق خاضه مع ليونارد دونغ، عارضا فيه صراحةً المناهج الداروينية في دراسة الوعي. كان اعتراضه جوهريًا بحق، ولذلك رحّبت بالفرصة التي أتاحها لي للردّ عليه ردًا موسّعًا ومفصّلًا، بلغ نحو خمسة عشر ألف كلمة، ووجّهته إلى مجموعة من النقاد دفعة واحدة.
وقد نُشرت هذه المقالة البحثية، المعنونة بـ«حول تطوّر الوعي وعلمه وميتافيزيقاه»، هذا الأسبوع بنظام الوصول المفتوح. وما سأقدّمه هنا ليس سوى عرض مبسّط لأفكارها الأساسية، موجّه إلى القارئ غير المتخصص.
كيف ندرس الوعي اليوم؟
إذا دخلنا مختبرات أبحاث الوعي المعاصرة، سنجد أن الغالبية العظمى من الدراسات تُجرى على البشر، وتعتمد اعتمادًا أساسيًا على التقارير الشفوية التي يقدّمها المشاركون عن تجاربهم الذاتية. تُستخدم هذه المعطيات بوصفها الأساس لبناء نظريات عامة عن الوعي، ثم تُمدَّد هذه النظريات — بدرجات متفاوتة من الحذر أو الجرأة — لتشمل حالات أخرى: الشمبانزي، والأخطبوط، والروبيان، وربما أنظمة الذكاء الاصطناعي. هكذا يُبنى علم الوعي اليوم: انطلاقًا من حالة بشرية خاصة، ثم تعميمها على ما سواها، بدل أن تُفهم ضمن سياقها التطوري الأوسع.
يُقرّ دي ويرد بأن أدوات البحث في علم الوعي قد اتّسعت، وأن الدراسات لم تعد حكرًا على الإنسان، بل شملت حيوانات أخرى كالقردة العليا. غير أنّه يرى في هذا التوسّع تعديلًا تقنيًا محدودًا، لا اعتمادًا حقيقيًا لمنهج دارويني في دراسة الوعي. فبحسب تصوّره، يمكننا أولًا تحديد مؤشرات المعالجة الواعية لدى جنسنا البشري، ثم استخدام هذه المؤشرات نفسها لاختبار وجود الوعي لدى الأنواع الأخرى. لكن هذا الافتراض ينطوي على إشكال عميق: إذ يفترض، ضمنيًا، أن الوعي واحد في جوهره، وأن اختلافاته عبر الأنواع ليست سوى فروق في الدرجة لا في الطبيعة. والحال أن الوعي قد يتخذ أشكالًا مغايرة جذريًا لدى كائنات تفصلها مسافات تطورية شاسعة عن الإنسان.
لا أنكر أن هذا النهج قادر على تحقيق بعض التقدّم، لكنه يظل أسيرًا للمرجعية البشرية، يدور في فلكها ولا يغادرها. في المقابل، يسعى المنهج التطوري «من الأسفل إلى الأعلى» إلى قلب زاوية النظر نفسها: إلى نقل مركز الثقل من الإنسان بوصفه معيارًا، إلى المملكة الحيوانية بأكملها بوصفها ساحة تنوّع وتجريب طبيعي. إنه انتقال من التفكير «من الأعلى إلى الأسفل»، حيث يُفهم الوعي انطلاقًا من ذروته البشرية، إلى تفكير يبدأ من أبسط أشكال الحسّ والخبرة، ثم يتتبع مسارات تعقّدها.
مع ذلك، يرفض دي ويرد هذا التوجّه، انطلاقًا من اعتقاده أن اعتماد منهج «من الأسفل إلى الأعلى» يستلزم تجاهل الأدلة البشرية كليًا. غير أن هذا اعتراض قائم على مغالطة واضحة: فالدعوة إلى إعادة ترتيب الأولويات التفسيرية لا تعني إقصاء المعطيات الإنسانية، بل تحريرها من وضعها الاحتكاري.
كيف ينبغي لنا إذن أن ندرس الوعي؟
لو وسّعنا النظر قليلًا إلى ما وراء مسألة الوعي، لبدت هذه المخاوف غير معقولة على الإطلاق. لا يوجد عالم أحياء تطوري يدرس الجهاز المناعي أو العين، ثم يقرر استبعاد البيانات المستمدة من الإنسان. على العكس، تُعرض الأدلة الخاصة بالإنسان العاقل جنبًا إلى جنب مع أدلة الأنواع الأخرى، لا بوصفها معيارًا أعلى، بل بوصفها حالة ضمن طيف أوسع. هكذا يعمل علم الأحياء التطوري فعلًا: بالمقارنة، لا بالمركزة.
المفارقة أن علم الوعي ظل، إلى حدّ كبير، علمًا بلا تاريخ. وحين يلتفت الباحثون إلى أصوله، فإنهم يفعلون ذلك غالبًا بسؤال ضيّق: متى وكيف تطوّرت سمات الوعي لدى الإنسان؟ تخيّل لو دُرست الرؤية بهذه الطريقة: نبدأ بشبكية العين البشرية، نبني نماذج شديدة التعقيد لرؤية الألوان، ثم نحاول الرجوع منها إلى الحيوانات الأخرى. عندها سنفشل في رؤية العيون المركّبة للروبيان، والعيون البسيطة للنوتيلوس، وسنغفل عشرات الابتكارات البصرية الغريبة التي أبدعها التطور. علم الأحياء لا يسعى إلى مقياس واحد للكمال الإنساني، بل ينشغل بتنوّع الأشكال، وبالطرق المتعدّدة التي تجد بها الحياة حلولها الممكنة. والوعي، إن أردنا فهمه حقًا، ليس استثناءً من هذه القاعدة.
هل الوعي ظاهرة تختلف، في جوهرها، عن سائر الظواهر البيولوجية، أم أننا اعتدنا التعامل معه على هذا الأساس دون مسوّغ حقيقي؟ لقد أحدثت أدوات داروين ثورة شاملة في علم الأحياء: الانتقاء الطبيعي، والتحليل الوظيفي، والتفكير التطوري. بهذه الأدوات كُشفت أسرار الإبصار، وأجهزة المناعة، والطيران، وغيرها من أعقد ابتكارات الحياة. والتخلّي عنها لا يعني سوى ارتدادٍ إلى علم الأحياء ما قبل داروين. وهذا، على وجه الدقة، هو الموقع الذي يقف فيه علم الوعي اليوم.
يزعم دي ويرد أن المنهج التطوري الذي أدافع عنه يفتقر إلى أدوات قادرة على التمييز بين العمليات الواعية واللاواعية دون الاتكاء على افتراضات إشكالية. غير أن هذا الزعم لا يصمد أمام التدقيق. فالمنهج التصاعدي لا يهجر أدوات المنهج التنازلي، بل يستوعبها ويضيف إليها أدوات علم الأحياء التطوري. كما أن المعطيات المتعلقة بأصول الحيوانات، وبنية الأدمغة، وأنماط عيش الأسلاف، تفرض قيودًا تفسيرية وتوفّر معايير يمكن من خلالها تقييم مدى معقولية أي نظرية عن الوعي.
إن النظريات التي تُشيّد تصوّرها للوعي على قدرات بشرية فريدة — كاللغة المركّبة، وما وراء المعرفة، والوعي الذاتي — تُخطئ في تحديد موضع التميّز الإنساني. فهي تفترض أن ما يجعلنا استثنائيين هو ما يجعل الوعي ممكنًا أصلًا. ومن هنا اقترحتُ فرضية «التعقيد المرضي»: الوعي لم ينشأ ليُنتج الكائن العاقل المتأمّل، بل ليساعد الكائنات ذات الأجسام المعقّدة على اجتياز مفاضلات حيوية صعبة. كانت جذوره الأولى مشاعر تقييمية بسيطة: إحساس بالخير والشر، أو بالجاذب والنفور، تُرشد الكائن إلى ما ينبغي فعله.
ويعترض دي ويرد كذلك على التفكير التطوري بحجة أنه مفرط في التخمين. غير أن هذا الاعتراض لا يكشف ضعف التفكير التطوري بقدر ما يكشف ضيق الأفق الذي حاصر به علم الوعي نفسه. فقد أدّى النهج التنازلي إلى عزل دراسة الوعي عن الأدوات التي غيّرت فهمنا لجميع الظواهر البيولوجية الأخرى. صحيح أن هذا العزل لم يكن بلا مبرّر في بداياته؛ فقد خاض علم الوعي صراعًا طويلًا لنيل الاعتراف والشرعية، وسعى باحثوه إلى إظهار أكبر قدر ممكن من الصرامة والموضوعية عبر تقليص مساحة التكهن. لكن ليس كل تكهّن نقيضًا للعلم. فكل علم يتناول الماضي السحيق يعمل، بالضرورة، في ظل شحّ الأدلة. وما يفعله العلماء في هذه الحالات هو بناء نماذج متنافسة، وجمع القرائن المتاحة، وتنقيح النظريات على ضوء ما يتكشّف تدريجيًا. هذا «التكهن» ليس ضربًا من الخيال الحر، بل ممارسة علمية مشروعة، مؤسسة على التجربة، ولا غنى عنها إذا أردنا فهم الوعي بوصفه ظاهرة بيولوجية نشأت وتحوّلت عبر الزمن.
أما التكهّن غير المبرَّر حقًا، فليس في التفكير التطوري ذاته، بل في الافتراض الصامت بأن الوعي ينبغي أن يُعامَل معاملة استثنائية، مختلفة جوهريًا عن سائر الظواهر البيولوجية. هذا الافتراض، الذي نادرًا ما يُصرَّح به، هو في حدّ ذاته أكثر جرأة وأقل سندًا من أي فرضية تطورية منضبطة.
إن دعوتي إلى ثورة داروينية في علم الوعي لا تنبع من قناعة بأن المناهج السائدة عاجزة، بالضرورة، عن تفسير الوعي البشري. بل تنبع من إدراكٍ أعمق لخطر آخر: خطر أن تُنتج هذه المناهج صورة مشوّهة للوعي، تُقدّمه بوصفه ظاهرة محصورة في الإنسان أو مُصمَّمة على مقاسه، متجاهلة كونه خاصية طبيعية نشأت وتحوّلت عبر ملايين السنين، وامتدّت بأشكال متعدّدة عبر ملايين الأنواع.
فإذا أردنا فهم عقول الأخطبوط، وعقول الغراب، وعقول الروبيان، بل وأولى الكائنات التي امتلكت بذور التجربة الذاتية، فلا مناص من التعامل مع الوعي بوصفه تكيفًا بيولوجيًا. أي بوصفه حلًّا تطوريًا لمشكلات بيئية محدّدة، يختلف شكله ووظيفته باختلاف أنماط الحياة والضغوط التي واجهتها الكائنات الحية. عندها فقط يمكن لعلم الوعي أن يتحرّر من مركزيته الإنسانية، وأن يلتحق أخيرًا بالعلم الذي غيّر فهمنا للحياة نفسها: العلم الدارويني.
والتر فيت، الحاصل على درجة الدكتوراه، هو محاضر في الفلسفة بجامعة ريدينغ.