بحثًا عن الكتاب الذي ينقذ الحياة
ترجمة : إقبال عبيد
بحثًا عن الكتاب الذي ينقذ الحياة
في مذكراتها غير التقليدية، تكشف سارة شيهايا عن علاقة مضطربة وحميمة في آنٍ واحد مع الأدب؛ علاقة لم تكن مجرد قراءة عابرة، بل تجربة وجودية أسهمت في صياغة شخصيتها وتكوين عالمها الداخلي.
للكتب أسرارها الغريبة في إنجاب المزيد من الكتب؛ فهي تترك أثرًا في قرّائها، يدفع بعضهم إلى الغوص في الكتابة بدافع الحب أو الكراهية، وكأن النص الأول لا يكتمل إلا بامتداداته. ومن هنا، وجد كتّاب السيرة غير الروائية في هذه الظاهرة أرضًا خصبة لتوسيع المشهد الأدبي، فراحوا يؤلفون نصوصًا جديدة تنبع من حوارٍ متواصل مع النصوص السابقة.
وفي العقدين الأخيرين، اكتسبت الكتب التي تروي تجربة القراءة نفسها – ما يُعرف بـ"المذكرات الببليوغرافية" – حضورًا متزايدًا. فهي لا تكتفي بسرد الحكاية الشخصية، بل تمزج بين التحليل الذاتي والتأمل النقدي، لتصوغ سيرة إنسان من خلال مرآة الكتب التي قرأها. في هذا النوع، تغدو النصوص بمثابة منارات تغير مسار الحياة، وتكشف للقارئ أبوابًا نحو ذاته.
تأمل مثلًا ما قدّمه الباحث الكلاسيكي دانيال مندلسون في كتابه أوديسة: أب وابن وملحمة (٢٠١٧)، حين أعاد قراءة هوميروس بصحبة والده الشيخ، ليكتشف كيف يمكن للأدب أن يعيد وصل خيوط علاقة عائلية تتنفس من جديد بين صفحات نصٍّ قديم. أو كتاب جين شابلاند سيرتي الذاتية لكارسون ماكولرز (٢٠٢٠)، حيث وجدت الكاتبة في أرشيف المؤلفة القوطية الجنوبية مرآة لأزماتها النفسية وتجاربها المؤلمة، لتتحول القراءة إلى فعل خلاص وتثبيت للذات في مواجهة هشاشتها.
قد تبدو المذكرات الببليوغرافية انعكاسًا لفرادات البشر والكتب التي تصاحبهم، غير أنّها غالبًا ما تُعيد إنتاج فكرة مألوفة: أنّ القراءة عملٌ نافع، فهي تُعلّم وتُهذّب وتُقرّبنا من ذواتنا ومن الآخرين. غير أنّ كتاب سارة شيهايا الجديد، بطابعه الممزوج بالسخرية السوداء، يشق مسارًا آخر؛ إذ يكفي أن نتأمل عنوانه – رهاب الكتب – لنفهم أنّه ليس نشيدًا احتفائيًا بقوة الأدب العلاجية، بل اعترافٌ جريء بكيفية تحوّل اعتمادها المفرط على الكتب إلى محور أزمة عميقة دفعتها، في مرحلة ما، إلى الخوف من القراءة نفسها.
ومع ذلك، فالعنوان لا يُترجم نفورًا من الكتب أو دعوة للتخلي عنها. بل على العكس، فقد أحبّت شيهايا القراءة منذ اللحظة التي تعلّمت فيها الأبجدية في سن الرابعة. في طفولتها، عاشت في ظلال عالم أفونليا الكندي الذي نسجته آن من الجملونات الخضراء، وفي شبابها، افتُتنت برواية استحواذ لأ. س. بيات. ومنذ ذلك الحين، غدت القراءة نهج حياتها وملاذها الأسمى. هذه الشغف قادها إلى جامعة برينستون، حيث سعت لتثبيت أقدامها كأستاذة للأدب الإنجليزي، وهناك وجدت نفسها مطالَبة بنشر دراسة نقدية معمّقة حول مفهوم أدبي، كشرطٍ لا بدّ منه لضمان بقائها الأكاديمي.
لكن، بدلاً من أن تنصرف سارة تشيهايا إلى إنجاز دراسة نقدية أكاديمية كما كان متوقعًا، كتبت رهاب الكتب؛ نصًّا يتجاوز حدود السيرة ليكشف كيف تشابكت علاقتها العميقة بالقراءة مع أزمة نفسية طارئة دفعتها إلى جناح للأمراض النفسية، حيث وُضِعت أمام التشخيص القاسي: اضطراب اكتئابي حاد. في تلك المذكرات، تعود تشيهايا إلى القصص التي شكّلت شخصيتها، كأنها تُعيد قراءتها من جديد لا بوصفها نصوصًا أدبية وحسب، بل كبذور دفينة لانهيارها، ومحاولات لتلمّس مسار مختلف نحو مستقبل أقل هشاشة. والنتيجة، نصّ يحمل ملامح إعادة تقييم عميقة لرغبة الإنسان في التلاشي داخل قصة، تلك الرغبة المعقدة التي تجمع بين الخلاص والفقد.
تفتتح تشيهايا عملها غير التقليدي بذكر تفاصيل إقامتها في المستشفى خلال شتاء ٢٠١٩. في تلك اللحظة الحرجة، لم تكن تواجه نوبة اكتئاب حاد فحسب، بل أيضًا آثارًا غريبة لرهاب الكتب الذي حمل عنوان كتابها. صحيح أنّ "رهاب الكتب" مصطلح سريري قائم – الخوف من الكتب – إلا أنّها لم تتوقف عند حدّه الطبي، بل اتخذته استعارة حية تنسج حولها روايتها الذاتية. فهي تصف حالتها بوصفها "قلقًا عامًا من القراءة، يصيب أولئك الذين ارتبطوا بالكتب ارتباطًا وثيقًا، ربما وثيقًا أكثر مما ينبغي"، وبأنها خوف من الكتب كفكرة في ذاتها، لا كأشياء مادية فقط. في عالمها الداخلي، كان الاكتئاب ورهاب الكتب يتغذيان على بعضهما، يضاعف كلٌّ منهما أثر الآخر في دوامة نفسية خانقة.
لقد وُلد رهاب الكتب لدى تشيهايا من رحم خوفٍ محدّد: كتاب واحد كان عليها أن تكتبه لتثبيت مكانتها الأكاديمية، لكنها عجزت عن إجبار نفسها على إنجازه. ومن هنا تحوّل ذلك الكتاب الغائب إلى شبحٍ خانق؛ رهاب الكتاب الذي شلّ قدرتها على القراءة نفسها. باتت غير قادرة إلا على التقدّم بضع فقرات قبل أن تتوقف، متسائلة في حيرة وقلق: "هل أنا على وشك الانهيار والجنون... أم أنني مجرد منهكة، خائفة من أن تكون مسيرتي – أي حياتي – قد انتهت قبل أن تبدأ؟"
ورغم أن إقامتها في المستشفى ساعدت في التخفيف من أكثر أعراض الاكتئاب حدّة، فإنها عمّقت مأزقها مع الكتب. خرجت من التجربة وهي تصف حالتها بأنها ضرب من العجز الجسدي الحاد: كانت تحدّق في الكلمات، صفًّا بعد صفّ، وكأنها رموز جامدة بلا معنى، غير قادرة على النفاذ منها إلى المعنى أو التماهي مع النصوص التي طالما شكّلت عالمها الداخلي. وهكذا، غدا الكتاب بالنسبة لها لا بوابةً للخلاص، بل جدارًا عازلًا يضاعف غربتها عن ذاتها وعن اللغة التي أحبتها.
قد يرى المراقب الخارجي أنّ ما مرت به سارة تشيهايا ليس أكثر من صورة مألوفة من صور الذعر المهني، ذاك القلق الذي يتفجر تحت وطأة عقارب الساعة وضغوط الحياة الأكاديمية. غير أنّ مذكراتها تكشف أن مسيرتها العلمية لم تكن سوى خلفية باهتة في مشهد أكثر عمقًا؛ فـ رهاب الكتب يتجاوز الوظيفة ليمتد إلى تاريخ طويل من علاقة مضطربة بالقراءة نفسها، علاقة وُلدت في طفولتها قبل أن تطأ قدماها "الحزام الناقل" للمؤسسة الأكاديمية.
نشأت شيهايا في أوهايو، ابنةً لمهاجرَين ياباني وكندية، ووجدت في الكتب ملاذًا من واقع مثقل: من مزاج والدها المتقلّب، ومن كراهية الذات التي عانتها في "الضواحي الأكثر بياضًا"، بل ومن نوبات الاكتئاب الشخصي التي دفعتها إلى ثلاث محاولات انتحار وهي بعد في الثامنة عشرة. غير أنّ انغماسها في القراءة لم يكن دواءً بسيطًا للعزلة أو عزاءً مؤقتًا للغربة، ولم يكن كافيًا ليخفف من قسوة الاكتئاب. على العكس، فقد تداخلت القراءة مع معاناتها حتى أصبحتا وجهين لعملة واحدة. تقول: "بالنسبة لي، أن أكون مكتئبة وأن أكون قارئة وكاتبة، هما أمران متشابكان منذ البداية. جميع أزماتي مرسومة على هوامش الروايات التي التهمتها مرارًا، أحيانًا لأشعر بالطمأنينة، وأحيانًا لأغرق في مزيد من اليأس."
في بداية رهاب الكتب، تُحدّد تشيهايا نصّين خياليين تنافسا طويلًا في تشكيل رؤيتها للعالم ولنفسها، وقدّما لها وهمًا مُريحًا للشكل وسط حياة بلا ملامح. الأول كان ذلك الكتاب الموعود، الذي كانت تؤمن أنّها ستجده يومًا ما إذا قرأت بما يكفي؛ كتابٌ سيكشف لها سرّ العالم ومكانتها فيه. أما الثاني، فكان كتاب حياتها الخاص، الذي تخيّلته قصيرًا ومأساويًا. بين هذين السرديْن المتناقضين، انطلقت قراءتها بيأس مستميت، بحثًا عن الكتاب الذي قد ينقذها من نفسها ومن مصيرها المحتوم.
على امتداد مذكراتها، تنقّب سارة تشيهايا في الكتب التي مرّت بها، باحثة عن تلك التي حاولت أن تنهض بالدور المنقذ. غير أنّ اللافت في رهاب الكتب أنّها لا تكتفي باستدعاء النصوص التي منحتها عزاءً أو سكينة، مثل آن في الجملونات الخضراء، بل تتوقف أيضًا عند الكتب التي تركت في روحها ندوبًا أعمق من أي تعزية. من بين أقوى صفحاتها فصلٌ مبكر تستعيد فيه قراءتها، وهي مراهقة في المدرسة الثانوية، لرواية توني موريسون العين الأكثر زرقة، النص الذي وصفته بأنه “مرعب، غير متوقع، وأساسي” في تكوين وعيها. كانت حينها فتاة تكره مظهرها وتؤذي نفسها، فوجدت في بطلة موريسون – بيكولا بريدلوف – مرآة مؤلمة.
بيكولا، الطفلة السوداء في لورين، أوهايو، بعد الكساد الكبير، تتعرض لسوء معاملة وقسوة عزّزت غربتها، حتى انزلقت إلى وهمٍ مرير بأنّها نالت العيون الزرقاء التي طالما حلمت بها. في هذا الوهم المأساوي، رأت تشيهايا المراهقة انعكاسًا حادًّا لذاتها. تقول: “لم يكن هذا اعترافًا يشبه دفء القراء حين يتعاطفون مع الشخصيات. بل كانت رغبة بيكولا الجامحة في عيون زرقاء، وإيمانها المتشظي بأنها امتلكتها، بمثابة كدمة غائرة لم أكن أعلم بوجودها. لقد تعرفت على شكل هذه الرغبة اليائسة، كما لو كنت أستطيع أن ألمس خطوطها القاسية بعينيّ الداكنتين الضيقتين المغلقتين بإحكام.”
هنا تكشف تشيهايا، من خلال تأمل شخصي متداخل مع قراءة نقدية، أنّ تأثير بعض الكتب لم يكن مُحرِّرًا أو باعثًا على الطمأنينة، بل كان جرحًا بحد ذاته، يرسّخ وعيًا جديدًا عبر الألم، ويجعل الأدب تجربة تُغيّر الحياة لا بالتخفيف من معاناتها، بل أحيانًا بتعميقها.
لا تقتصر رحلة تشيهايا على مواجهة الكتب التي تركت جراحًا في وجدانها، بل تمتد أيضًا إلى النصوص التي منحتها لذة عظيمة، وإن حملت معها دروسًا مُضلِّلة التصقت بها طويلًا. تتحدث عن أول لقاء لها مع رواية الاستحواذ لأ. س. بيات – حكاية شعراء فيكتوريين واكتشاف أكاديمي – بوصفه أشبه بقصة حب عاصفة؛ كتاب أيقظ فيها توقًا جامحًا إلى مغامرة لا تنتهي في دهاليز الدراسة الأدبية. كان هذا النص هو الذي علّمها نشوة القراءة المتعمقة، وفتح لها طريق المهنة، لكنه في الوقت ذاته كشف عن خطر الإفراط في التفسير. إذ راحت تُسقط أدوات التحليل على كل شيء: الأشخاص، والكتب، والأحداث. حتى الحياة اليومية بدت لها نصًّا مفتوحًا للتحليل، الأمر الذي جعلها تشعر بالأمان داخل قوالب التأويل، لكنه في المقابل حوّل أصدقاءها إلى شخصيات مسطّحة، وجمّد إحساسها بذاتها. تكتب بمرارة أنّ أخطر فكرة تمسّكت بها بإصرار هي أنّها "قضية خاسرة".
ومن المفارقات التي تكشف عنها المذكرات الببليوغرافية أنّها، رغم سحرها، قد تُشبه قراءة أحلام الآخرين: تجارب غريبة، شخصية، لا يسهل النفاذ إلى عمقها. هكذا بدا رهاب الكتب، بعيدًا عن الجفاف الأكاديمي، لكنه مشبع بجاذبية التجريد التي ربطتها شيهايا باكتئابها. فهي تعترف: "كقارئة، أغوص دومًا في عوالم الخيال. ككاتبة، أجدني عاجزة عن صياغة عبارات مباشرة... وفي لحظات ضياعي القصوى، أرى نفسي أتفتت وأذوب في كل شيء وكل شخص آخر."
بهذا البوح، تُظهر كيف أن القراءة، حتى حين تبدو خلاصًا، يمكن أن تتحول إلى قوة مدمّرة، تُعيد صياغة الذات وتذيب حدودها حتى تكاد تختفي.
حين جاء التشخيص بالاكتئاب، كتبت سارة تشيهايا أنها شعرت وكأنها انضمّت فجأةً إلى جمعية دولية غير مرئية، تتألف من أشخاص يتشاركون معها الوصم نفسه: المصابون بالاكتئاب رسميًا. كان في ذلك الاعتراف شيء من العزاء؛ حبكة جديدة لحياتها، هذه المرة مبنية على الواقع لا على أوهام الخيال. وللمفارقة، كان هذا الوعي ذاته هو ما ساعدها في نهاية المطاف على إيجاد طريقها للعودة إلى القراءة.
لم تُعلن أنّ العتمة قد انقشعت أو أنّ اللحظات المظلمة انطوت إلى غير رجعة، لكنها أقرت بأن إدراكها أنّ “النهاية لم تكن النهاية” في كتاب حياتها، قد فتح أمامها آفاقًا جديدة للوجود. لقد صارت ترى الكتب والعالم من حولها بعين مختلفة؛ عين لا تبحث عن القصة النهائية التي تفسر كل شيء، بل تتقبل الغموض كجزء من نسيج الحياة. تقول: “أحاول الآن أن أترك الحياة تجري كما هي، وأن أتحرك في العالم من غير أن أبني قصة محددة مسبقًا أتمسك بها.”
إنها حكمة تستخلصها تشيهايا من صميم التجربة: ربما ليس خلاصنا في العثور على الكتاب الذي يجيب عن كل الأسئلة، بل في استعدادنا للعيش مع الصفحات الفارغة التي لم تُكتب بعد، وللسير بشجاعة داخل مناطق الالتباس التي لا تُمنح تفسيرًا سهلًا.


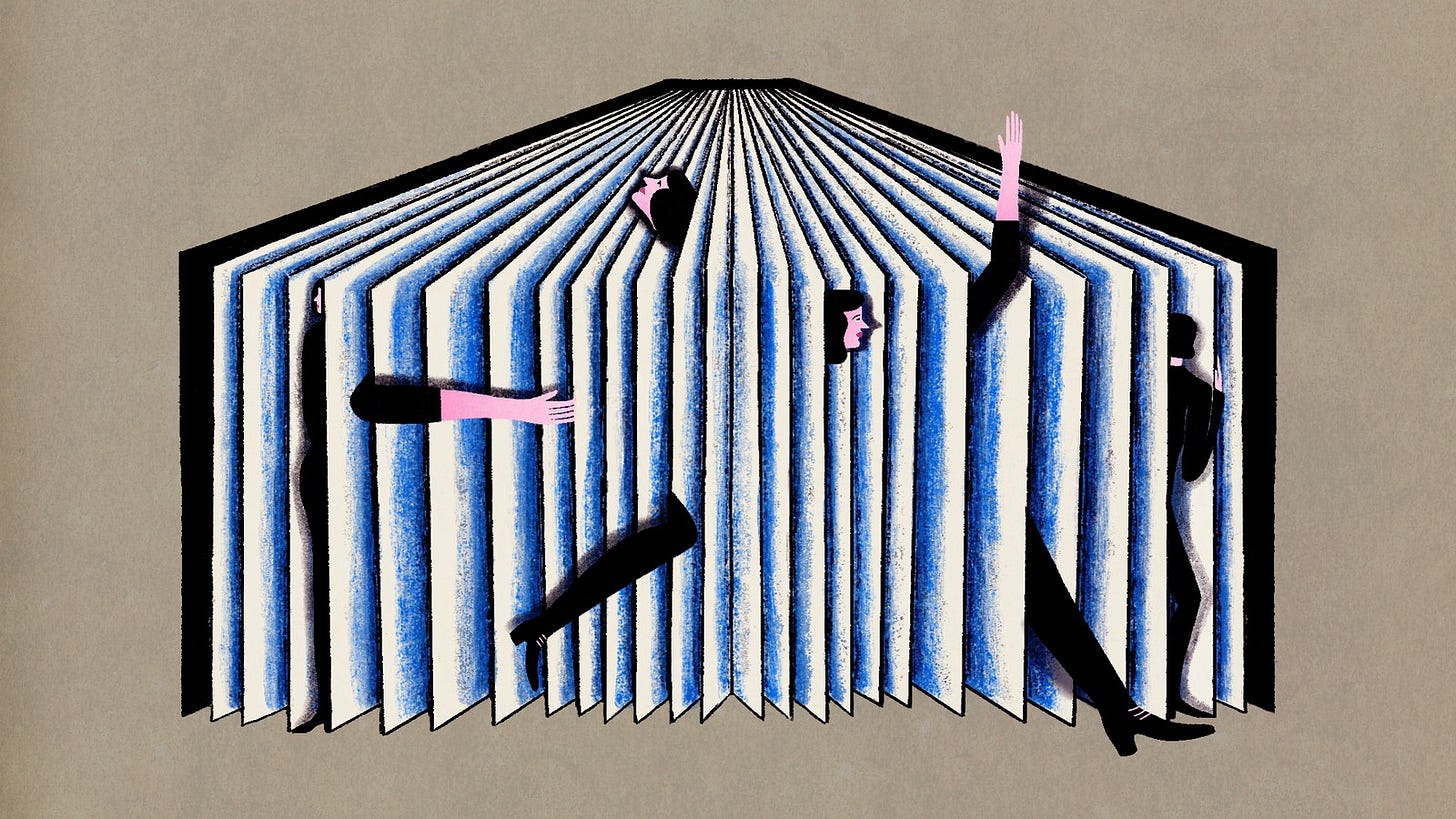


ترجمتك راقية عزيزتي أقبال ♥️سلمت يداك
وجدت ضالتي هنا، ممتنة..