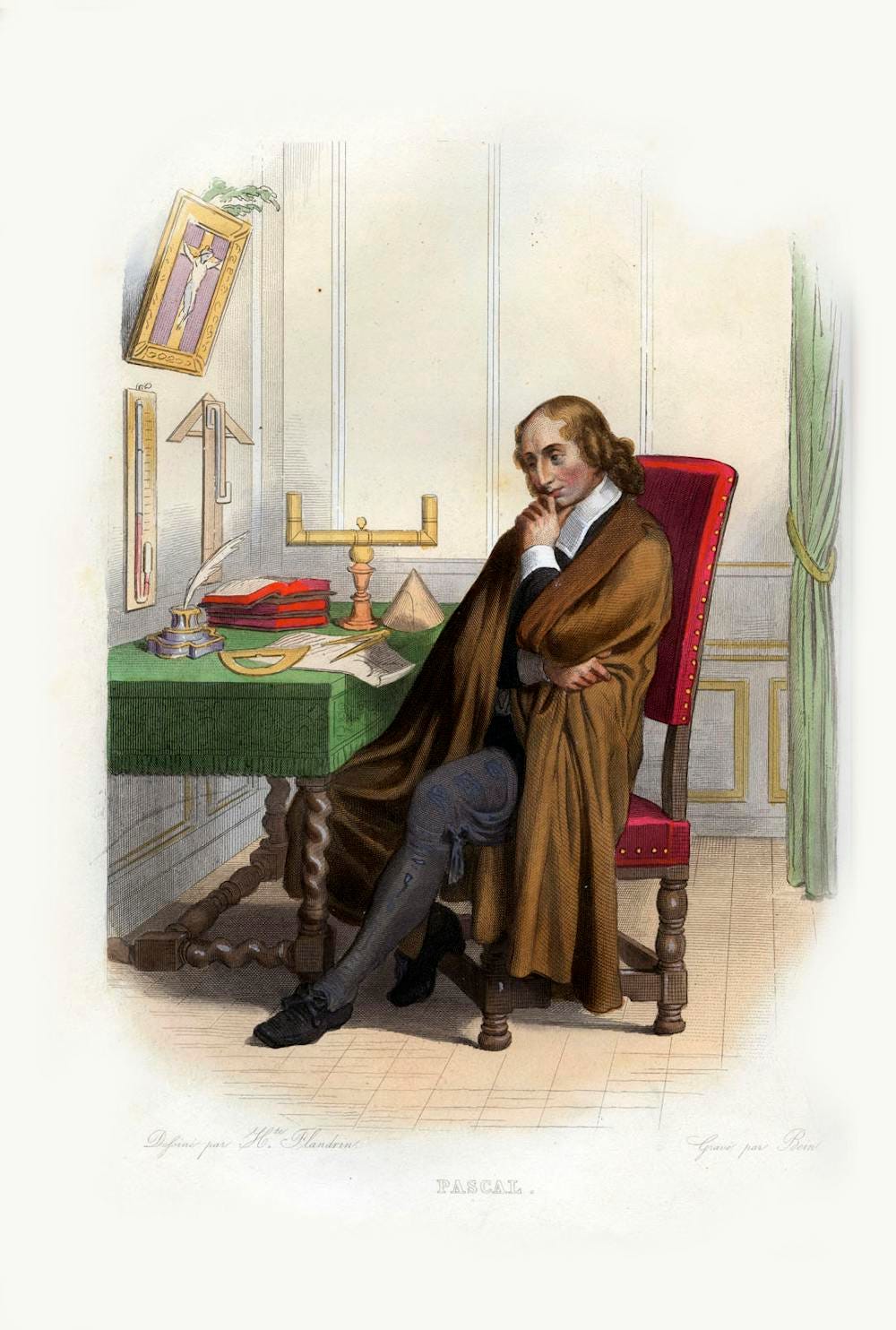كل مصائب الإنسان تنبع من أمر واحد: أنه لا يعرف كيف يجلس بهدوء في غرفة
باسكال في وحدته
يقول بليز باسكال: “كل مصائب الإنسان تنبع من أمر واحد: أنه لا يعرف كيف يجلس بهدوء في غرفة.”
تعريب : إقبال عبيد
نحن جميعًا معرّضون للتشتّت، وميلُنا إلى الانشغال الدائم ليس بريئًا كما يبدو؛ إنه غالبًا شكلٌ من أشكال الهروب من مواجهة ذواتنا في لحظات الصمت. ولعلّ هذا الهروب هو أحد أعظم ما يحول بين الإنسان وبين حياة ذات معنى، لأن المعنى لا يُولد في الضجيج، بل في القدرة على الاحتمال: احتمال السكون، واحتمال النفس، واحتمال الحقيقة عندما تظهر بلا زينة. ومع ذلك، يرى بوديباكسا أن ما يدفعنا إلى التشتّت ليس شرًا محضًا؛ بل هو في جوهره طاقة إبداعية، وإذا أُحسن توجيهها فإنها لا تقود إلى الضياع، بل قد تصبح طريقًا للوعي والتنوّر.
وقد لطالما استوقفتني هذه العبارة ” لباسكال؛ لأنها لا تُدين الإنسان بقدر ما تفضحه بصدق: فهي تذكّرني أن غياب السلام الداخلي ليس مرضًا حديثًا، ولا عارضًا طارئًا في زمن السرعة، بل هو تجربة إنسانية قديمة، عاشها البشر في كل العصور. فالملل، والشك في الذات، والوحدة، والعصبية، والقلق، والتوتر؛ ليست سوى أسماء مختلفة لحالة واحدة: أن يعيش الإنسان دون مصالحة مع داخله. وأنا أيضًا مررتُ بنصيبي من ذلك، وأدركتُ أن المشكلة ليست في العالم بقدر ما هي في قدرتي على الجلوس مع نفسي دون أن أهرب منها.
ومثل كثيرين، لديّ نموذجٌ أحتذي به في السكينة والطمأنينة. وأنا أُكافح في حياتي لأعيش، وأحيانًا لأُنجز شيئًا ذا معنى، ولا يفارقني ذلك الأمل المراوغ بأن الحياة ستصبح في المستقبل—بعد أسابيع قليلة أو ربما العام المقبل—أوسع صدرًا وأخفّ عبئًا، وأنني سأمتلك وقتًا أطول للتأمل والتفكير، وللقيام بما أراه ذا قيمة حقيقية. لكن ما إن أحصل، بحكم ظروف نادرة، على بعض الوقت الحر، حتى أجد نفسي سريعًا أُفكّر فيما يمكنني أن أملأ به هذا الوقت؛ فأعود، كأنني لم أتحرّك خطوة، إلى نقطة الصفر.
القلق جزء من طبيعة الإنسان.
فالقلق ليس حالة طارئة، بل هو سمة بشرية أصيلة؛ إنه اندفاعٌ دائم نحو ما نظنّه أفضل مما نحن فيه الآن. وتُسمي البوذية هذا الشعور بـ “تانها”، أي العطش: عطشٌ يسكن أعماقنا ويأخذ شكل عدم الرضا، ويدفعنا باستمرار إلى البحث عن المعنى والسعادة. غير أننا—في الغالب—لا نسير فعلًا نحو المعنى والسعادة، بل نتحرّك فقط. نتحرّك دون بصيرة، دون وعي بالنفس، وكأن الحركة بذاتها هي الخلاص. ولذلك ننزلق، بلا انتباه، إلى ما نسمّيه “تسلية”؛ وهي كلمة تُستخدم عادةً بمعنى تشتيت الانتباه، بينما معناها الأصلي هو الابتعاد عن الشيء. نحن نتسلى لكي نبتعد عن أنفسنا، ونملأ حياتنا بالمشاغل والتفاصيل والمشتتات، فنكبح عطشنا مؤقتًا، وفي غمرة النشاط يخفّ وعينا بمعاناتنا، أو يتوارى تحت الضجيج.
وغالبًا ما يكون أول ما يواجهه الإنسان حين يبدأ التأمل هو صدمة واضحة: اكتشافه حجم التشتت الذي يسكنه، وكم هو أسيرٌ لعادته في الهرب.
لكن لا مفرّ في النهاية من لحظة يعود فيها الشوق إلى الهدوء؛ حين نُنهك من الركض، أو نملّ من الأنشطة التي نُبدّد فيها أنفسنا. قد يبدو السعي وراء السعادة ممتعًا، لكنه لا يُشبع ذلك التوق العميق إلى المعنى والطمأنينة. وفي قلب الانشغال ذاته، يعود العطش ليظهر من جديد، ويفرض نفسه كحقيقة لا يمكن خداعها طويلًا، دافعًا إيّانا نحو السكون. وهكذا ندور في حلقة مفرغة: نشاطٌ يستهلكنا، ثم توقٌ إلى الراحة، ثم لحظات قصيرة من طمأنينة هشّة، ثم رغبة متجددة في النشاط—وكأننا لا نبحث عن الحياة بقدر ما نبحث عن مهربٍ منها.
حين نتوقّف ونتأمّل إن أسعفتنا الظروف بقليل من الوقت وبقدرٍ كافٍ من الصفاء—نرى هذه الدوامة بوضوح: الحركة التي لا تنتهي، والبحث الذي لا يصل، والانشغال الذي لا يُشبع. عندها ينهض في داخلنا شعورٌ صريح بعدم الرضا عنها، لا بوصفه تذمّرًا عابرًا، بل بوصفه إدراكًا وجوديًا بأننا نعيش على غير ما نحتاج. في تلك اللحظة نقرّر أن نتخلّى عن عادتنا القديمة في تجاهل احتياجاتنا الحقيقية، وأن نكفّ عن تسكين الألم بالتشتّت، وأن نبذل جهدًا واعيًا للعثور على معنى أصيل لحياتنا. وهنا يظهر دور التأمّل واليقظة الذهنية: بوصفهما طريقًا لاستعادة الذات، لا تقنيةً للهروب منها. نصل إلى مرحلة يصبح فيها الروتين اليومي مستهلكًا ومملًا وعديم الجاذبية، فنفهم أخيرًا أن المشكلة ليست في الأيام، بل في الطريقة التي نسكن بها داخلها، وأن علينا أن نعمل بجدّ مع أنفسنا كي يحدث التغيير الحقيقي.
القلق الداخلي، مهما أرهقنا، ليس عدوًا دائمًا؛ إنه في جوهره قوة دافعة، تدفعنا إلى الأمام وتمنعنا من التصلّب في حياة لا تشبهنا.
وما التأملأت و اليقظة الذهنية بمعناها الأوسع إلا تعلّمٌ حقيقي لكيفية الجلوس بهدوء في غرفة. غالبًا ما يكون أول ما يلاحظه الإنسان حين يبدأ التأمّل هو مقدار تشتّت ذهنه، وكأن العقل صندوقٌ مفتوح لا يكفّ عن الضجيج. لكن هذا الاكتشاف ليس هزيمة؛ إنه بداية الفرصة الأولى لتعلّم السلام الداخلي. فعندما نرى اضطرابنا على حقيقته، يصبح أمامنا خياران واضحان: أن نغضب ونُحبط، أو أن نُسامح أنفسنا. صحيحٌ أن الأمر يحتاج إلى وقت وممارسة، لكننا نتعلّم تدريجيًا أن العقل ليس آلةً يمكن إسكاتها بإرادة مباشرة. والمفارقة أن قبول هذه الحقيقة يجلب قدرًا كبيرًا من السلام؛ لأننا نصبح أقل انشغالًا بالصراع مع أنفسنا، وأكثر قدرة على مشاهدة أفكارنا دون أن نُستَعبد بها.
وحين يتضح هذا المشهد الداخلي، يصبح “التانها” ذلك العطش الذي يدفعنا للبحث عن حياة أكثر إرضاءً—أكثر حضورًا في وعينا وأقل غموضًا. لا يعود عطشًا أعمى يجرّنا إلى أي شيء، بل يتحوّل إلى إشارة يمكن قراءتها وفهم اتجاهها. ننمّي إحساسًا داخليًا بأن طريق السعادة لا يبدأ بالهرب من النفس، بل بمواجهتها؛ وأن علينا أن نُغيّر الحالات الذهنية التي تُنتج التعاسة، وأن نرعى ونُنمّي تلك الحالات التي تمنحنا شعورًا أعمق بالرضا والمعنى.
وقد انتهيتُ إلى حقيقة بسيطة لكنها قاسية: إن كثيرًا من تعاسة الإنسان تنبع من أمر واحد—أنه لا يعرف كيف يسترخي بهدوء في غرفة.
حين نتعلم الجلوس مع أنفسنا، لا يحدث شيء خارق في الظاهر، لكن يحدث تحوّل جذري في الداخل. نتعلّم ببساطة أن نراقب أفكارنا بدلًا من أن نُسلّم لها زمامنا وننغمس في أوهامها. ومع المراقبة يتعمّق وعينا، لأننا لم نعد غارقين داخل الفكرة، بل أصبحنا خارجها قليلًا، نلاحظها كما نلاحظ سحابة تمرّ. ومن هذا الابتعاد البسيط يتكوّن الصبر، ويتسع المجال بين الانفعال وبين رد الفعل. نكتشف أن التخلي عن الغضب ليس ضعفًا بل تحرّر، وأن اللطف ليس ترفًا أخلاقيًا بل حالة عقلية قابلة للتدريب. ومع الوقت يصبح العقل أقل اضطرابًا، ويكبر فينا الإحساس بالهدوء، ليس لأن الحياة صارت سهلة، بل لأن علاقتنا بداخلنا لم تعد عدائية. بدلًا من الاستنزاف اليومي في الصراعات الداخلية، ينشأ شعور بالراحة، وتنبثق السعادة من مكان لم نكن نراه من قبل. ثم يبدأ المعنى في الظهور: تشعر الحياة وكأن لها وجهة، وتبدأ الثقة بالنفس بالتكوّن لا كغرور، بل كطمأنينة هادئة نابعة من وضوح الداخل.
وفي المقطع ذاته من كتابه خواطر، يلتقط باسكال جوهرًا مؤلمًا في طبيعتنا البشرية: رغبتنا في اللهو ليست مجرد ميلٍ إلى المتعة، بل هي وسيلة دفاع عميقة ضد إدراك فنائنا. فنحن، كما يقول، نحمل في داخلنا “ضعفنا وفناءنا” بوصفهما مصيبة طبيعية تجعلنا عاجزين عن العزاء. وجود الإنسان وجودٌ مشروط وزائل: قد لا نكون وُلدنا أصلًا لو اختلت الظروف، ومن المؤكد أننا سنموت مهما ظننا أن الوقت طويل. من هنا يتكوّن خوفٌ عميق من العدم، خوفٌ لا نحب أن نواجهه، فتسعى الأنا إلى تعمية نفسها عنه؛ تنهمك في الملهيات، وتُقصي أي فرصة للصمت، لأنها تعرف—ولو غريزيًا—أن التأمل يفتح الباب أمام الأسئلة التي تهرب منها.
لكن التأمل، بدل أن يزيد هذا الخوف، يبدأ بتفكيكه من الداخل. فمع استمرار مراقبة العقل، نكتشف حقيقة حاسمة: كل ما ينشأ في التجربة الإنسانية زائل. الأحاسيس تذهب، والأفكار تتبدّد، والمشاعر تتبدّل، حتى الصور التي نحسبها “نحن” لا تثبت على حال. لا نعثر في داخلنا على شيء دائم يصلح أن يُسمّى “ذاتًا” بمعناها الصلب. كل شيء يتحرّك ويتحوّل بلا توقف. وهنا يبرز السؤال بصورة أكثر جرأة: إذا كان كل شيء يتغير، فأين هي تلك الذات التي تخاف الفناء؟
مع التعمّق في التأمل، نبدأ في إدراك أن “الموت” ليس حدثًا يقع في نهاية العمر فقط، بل يحدث في كل لحظة. فالتغيير هو شكلٌ من أشكال الموت: كل لحظة ينقضي فيها شيء منّا يُصبح ماضيًا، وكل لحظة تتشكل فيها حالة جديدة هي ولادة أخرى. وإذا كان الموت يحدث في كل لحظة، فإن الولادة الجديدة تحدث أيضًا في كل لحظة. كل تغيير يُنهي شيئًا ويُنشئ شيئًا آخر. وحين ننظر بعمق أكثر، نكتشف أننا ربما خدعنا أنفسنا حين تخيّلنا وجود “شيء ثابت” يتغير. فليس ثمة جوهر صلب يمرّ عبر الزمن كما تمرّ الأشياء؛ ما يوجد في الحقيقة هو عملية، حركة، تدفّق مستمر، لا ذات ثابتة وراءه كما تصوّرنا.
وعند هذه النقطة تفقد الأنا شكلها القديم: تتلاشى لا بمعنى الفناء الجسدي، بل بمعنى انكشافها كفكرة مُصطنعة، كنموذج ذهني اعتدنا تصديقه. وحين تزول الأنا بهذه الطريقة، يزول معها الخوف الذي كان يحرسها. لا يعود هناك “شيء” نخشى فناءه، لأن ما كنا نعدّه “شيئًا” لم يكن إلا سلسلة حالات متغيرة. يفقد الموت شوكته، لأن الخوف كان متعلقًا بالذات المتوهمة لا بالحقيقة. عندها تستعيد الحياة معناها الأعلى: لا يعود الإنسان مطاردًا بزمنٍ يهرب منه، بل حاضرًا في لحظته. ينتصر الرضا على القلق، لا لأن العالم تغيّر، بل لأن الداخل توقّف عن مقاومة الحقيقة.
عليّ أن أستمر في رفض المشتّتات، كي أقول “نعم” لأحلامي.
ولا ينبغي النظر إلى “التانها” بوصفها قوة شريرة، أو حتىوفق المصطلح البوذي قوة “غير ماهرة”. إنها في جوهرها طاقة داخلية جبّارة تدفعنا إلى الأمام: رغبةٌ لا تهدأ في حياة أوسع، وفي معنى أصدق، وفي اكتمالٍ لا نعرف له تعريفًا واضحًا. لكن هذه الطاقة، إن تُركت بلا وعي، تتحول إلى دوّامة تبتلعنا؛ تدفعنا إلى تكرار الأخطاء ذاتها، وإلى السعي وراء البدائل ذاتها، وإلى الامتلاء الكاذب ذاته. أمّا حين تُضاء بالوعي، فإنها تصبح قوة هداية؛ لا تسوقنا إلى مزيد من التشتّت، بل تقودنا إلى رضى أعمق وسعادة أقل هشاشة.
وفي حياتي الخاصة، أدركتُ أنني أعيش حلمي بأن أكون كاتبة متفرغة. غير أن هذا الحلم لا يتحقق بالحماس وحده، بل يحتاج إلى انضباط صارم ووعي دائم. عليّ أن أتجنّب الإغراءات، حتى تلك التي تبدو لي جميلة ومُرضية، مثل التدريس؛ لأن بعض المغريات ليست “سيئة”، لكنها لا تزال تُزاحم الوجهة الأساسية وتسرق طاقتي بصمت. عليّ أن أتمرّن على الرفض، لا كنوعٍ من القسوة على النفس، بل كنوعٍ من الاحترام لها: أن أرفض المشتّتات، حتى الإبداعية منها، كي أقول “نعم” للحلم الذي اخترته.
وهذا تحدٍّ قاسٍ في الحقيقة؛ لأن أكثر ما يُخيف في تحقيق الحلم ليس الطريق إليه، بل الوصول. فحين تقترب من حلمك حقًا، قد تكتشف فجأة أنه ليس ما كنت تتصوره، وأنه ليس بالضرورة ما تريد فعله إلى الأبد. عندها يصبح السؤال مؤلمًا: إذا حققتُ حلمي واكتشفتُ أنه لا يُشبهني، فأين سأقف؟ ومع ذلك، يبقى هذا المسار مُجزيًا ومُغذّيًا؛ لأنه لا يمنحك نجاحًا فقط، بل يمنحك معرفة أعمق بذاتك.
وفي الوقت نفسه، عليّ أن أحتفظ بوعيٍ أشدّ عمقًا: لا توجد مهنة ولا حتى الكتابة قادرة وحدها على منحي السعادة الحقيقية. لا وظيفة تستطيع أن تملأ الفراغ الوجودي الذي يسكن الإنسان، ولا إنجاز قادر على تحويل القلق إلى سلام دائم. لذلك عليّ أن أتقبّل حقيقة ضعفي وفنائيتي، وأن أُنمي بصيرتي بدل أن أتهرب منها. عليّ أن أتعلم كيف أجلس في غرفة هادئة دون أن أكتب، لأن القدرة على الكتابة ليست معيار النجاة، بل القدرة على السكون. أن أكون مع نفسي دون مشروع، ودون إنجاز، ودون دليلٍ خارجي يثبت أنني أستحق الحياة.